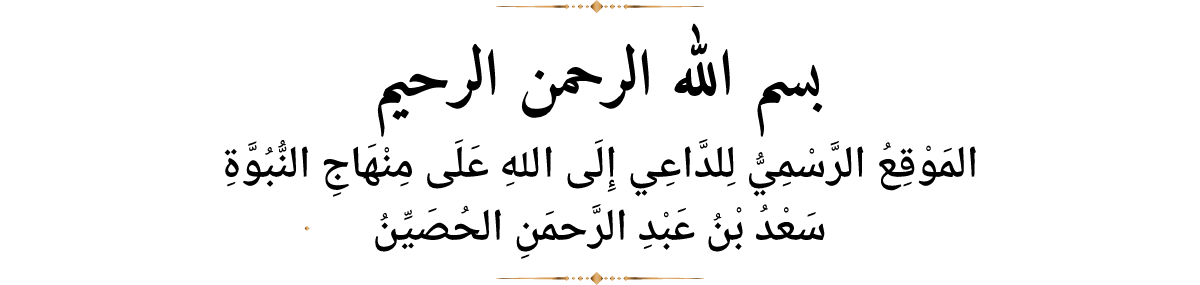رأي في الديمقراطية
رأي في الديمقراطية
بسم الله الرحمن الرحيم
أ ـ معظم النظريات الإدارية والسياسية تبدو صالحة قبل اختبارها بالعمل، ووراءها في غالب الأحوال رغبة في الإصلاح، كما شهد الله لشرّ خلقه بأنهم: {يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأعراف: 30] وأنهم: {هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 104]، ثم يظهر النقص بالتمحيص والاختبار، قال الله تعالى عن كتابه الكريم: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].
ب ـ ونظرية الديمقراطية (ومعناها: حكم الشعب بالشعب) عندما اختبرت بالعمل أول مرة (في اليونان قبل 2500 سنة) لم تكن غير محاولة فكرية سياسية لاصلاح الولاية، لا علاقة لها بعبادة الله الحق، ولا بعبادة أوثان الآلهة المفتراة، ولا بالحكم بين الناس: وبلغت الديمقراطية أوجها بتفتيت الإدارة المركزية اليونانية فيما سُمِّي: (ولاية المدينة) أو (المدينة الولاية). وبعد مئة عام من بداية التنفيذ اكتسحتها جيوش الإدارة المركزية المقدونية ثم الرومانية، ولم ينقذها بريق النظرية ولم تحمها نية الإصلاح.
ج ـ وقامت الديمقراطية (النظرية) على قاعدتين جذابتين:
1) افتراض وجود حقوق طبيعية أساسية تولد مع الفرد ولا يجوز أن تسلب منه إلا بالموت: حرية الفكر وحرية القول وحرية العمل وحرية الدين.
ولا يصح أن تؤخذ هذه الحقوق على إطلاقها؛ فلو صح إطلاق هذه الحريات في اليونان الوثنية أو لِوَرَثتها ممن يفصل الدين عن الدولة ـ جدلاً ـ لما صلحت لمن يعبد الله وفق شرعه، فحرّيته مقيدة بنصوص الشريعة، ثم بالمصلحة العامة فيما لا نص فيه.
2) المساواة في الحقوق والواجبات، وبخاصة في توزيع المال العام.
وهي فكرة خيالية أيضاً ـ باطلاقها ـ مخالفة للفطرة التي فطر الله خلقه عليها: عدم التساوي في الخلق ولا الخُلق ولا الرزق ولا العقل ولا الحال ولا المآل، قال الله تعالى: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف: 32]، وفي عهد الديمقراطية المثالية اليونانية ـ فضلاً عن غيرها ـ لم تتحقق المساواة فكان الشعب اليوناني طبقتين: سادةً، وعبيداً؛ مسخرين لخدمة السادة كما كانت في عهد فراعنة مصر.
د ـ وكان من خير ما حققته الديمقراطية في الماضي والحاضر وأقربه إلى فطرة الله لخلقه وشرعه لهم: الإقرار بأن المرء برئ حتى تثبت إدانته، وهو ما يعز وجوده اليوم في البلاد المنتمية إلى الإسلام فضلاً عن غيرها ممن يرفض الدين والديمقراطية.
هـ ـ وجاءت الديمقراطية الحديثة إلى أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر (الكريكوري) فكان أبرز رمز في ثورة الشعب الفرنسي: سقوط (الباستيل) وتحرير سبعة من أعتى المجرمين كانوا هم كل سجنائه. واقترفت ديكتاتورية الشعب الثائر أشنع جرائم الاعتداء والقتل والتشريد والتخويف والحقد والظلم في حق كل من يتهمه عضو واحد من أعضاء جمعية الأمن الشعبي (الظلم اللاحق) بالتعاون مع المتهمين بالظلم السابق، دون تحقيق ولا محاكمة عادلة، ولعل أصدق وأصوب ما رُوي عن إحدى ضحايا الثورة: (أيتها الحرية كم باسمك تُقترف الآثام).
ثم تلت الدكتاتورية الشعبية الغوغائية: دكتاتورية (دانتون) و(روبسبير) الفردية، واستمر الظلم وسفك الدماء بضعة أعوام قبل استقرار النظام الفرنسي والأوروبي في شكله الدستوري الحاضر، المسمى في العربية الدارجة: علمانياً.
و ـ وكان من أسوأ ما افرزته الديمقراطية المقلَّدة والمقلِّدة: الانتخاب العام والحزبية والإضرابات والمظاهرات. فلم يحقق الانتخاب العام اختيار أفضل الولاة لسببين:
1) أن القوة تختفي أو تظهر ـ دائماً ـ وراء أغلبية الأصوات؛ قوة الحزب أو قوة المال أو قوة الدعاية أو قوة الإرادة والمثابرة.
2) أن أكثرية الناس ـ في كل زمان ومكان ـ هم أقلهم علماً وعقلاً وإيماناً وخُلقاً، قال الخالق ـ تعالى ـ عن أكثر خلقه: {ولكن أكثر الناس لا يشكرون}، {لا يعلمون}، {لا يؤمنون}، {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الأنعام: 116]، {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} [يوسف: 103]، وقال الله تعالى عن ذرية نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام: {وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: 26]، ولهذا كان أقرب طرق اختيار الولاة إلى شرع الله وفطرته: بيعة النخبة من أهل الحل والعقد (أهل العلم)، وهم القلة في كل زمان ومكان، قال الخالق ـ تعالى ـ عن خلقه: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13]، {إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24]، وعلى هذا اتفق علماء الأمة أن بيعة أهل الحل والعقد لولي الأمر مهما قل عددهم ملزمة لبقية الأمة، وعلى هذا تمت البيعة للخلفاء الراشدين المهديين ومن سلك سبيلهم. وتعدد الأحزاب الدينية والدنيوية مرض يَفري جسد الأمة ودينها، ويذهب ريحها ويفرّق شملها، لأن كل حزب يفرح بما لديه وبالتالي يمقت ما لدى غيره، قال الله الخالق ـ تعالى ـ وهو أعلم بخلقه: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون: 53]. والإضرابات والمظاهرات وسائل (غير مشروعة ولا معقولة) لفرض رأي أو مصلحة فئة من الناس على حساب الآراء والمصالح العامة لبقية الأمة، ويزيد الأمر سوءاً (في البلاد المقلِّدة) بالإفساد في الأرض وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة وقتل النفس التي حرم الله بغير حق.
ز ـ ومما تقدم يتبين أنه لا علاقة للديمقراطية بعقيدة معينة، فاليونان ـ حيث بدأت ـ تدين بالوثنية، وأوروبا وأمريكا ـ حيث توجد الآن ـ يدين أكثر أهلها بالنصرانية، وليست في البداية ولا في النهاية غير منهاج سياسي، وقد انتمت إليها الاشتراكية أو الشيوعية منهاجاً اقتصادياً وهي لا تدين بدين صحيح ولا باطل.
ح ـ وأول محاولة لفرض رأي شعبي على ولاة الأمر في تاريخ الإسلام كانت ثورة الخوارج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، بدعوى: عدم المساواة في توزيع الأموال والمناصب العامة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة الذين أمر نبي الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أمته باتباع سنتهم والعض عليها بالنواجذ، وشهد لهم بالجنة، ومات وهو عنهم راض. بل ميزه رسول الله بشهادته له أنه ” رجل تستحي منه الملائكة“ وبيّن أنه سيموت شهيداً.
ولم يرضخ عثمان رضي الله عنه وأرضاه للغوغائية الشعبية، فلم يقبل التنازل عما ولاه الله عليه، وكان ذلك منه اتباعا لشرع الله وهو أعلم به من جميع الثائرين عليه، وقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: ” إن الله عسى أن يُلبسك قميصاً، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تفعل“. وباء الثائرون عليه بإثم سفك دمه، وباؤوا بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبايعته الصحابة ألا ينازعوا الأمر أهله (متفق عليه)، وأمره أمته بالسمع والطاعة ” وإن ضُرِب ظهرك وأُخِذ مالك“ رواه مسلم. وأمره أمته بالصلاة وراء أمرائهم بَرِّهم وفاجرهم ” إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم“ وبالصلاة وراءهم نافلة وإن أخروا (أو أماتوا) الصلاة عن وقتها (مسلم). وكانت النتيجة ـ كالعادة مِنْ قبل ومِنْ بعد ـ إيقاظ الفتنة النائمة وفتح أبواب من الشرّ والفساد لا تكاد تغلق إلا أن يشاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه وآله وصحبه وأتباعه.