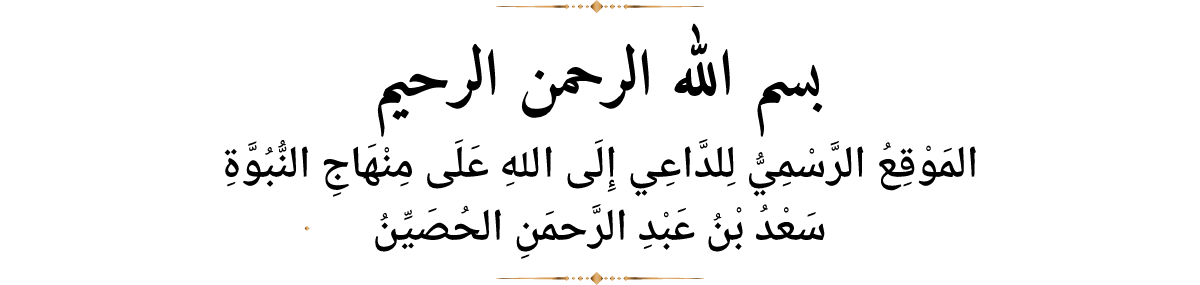الدعوة إلى الله بين اليسر والعسر [نقد فكر منّاع قطّان أول وآخر مرشد معروف لحزب الإخوان المبتدع في السّعودية]
الدعوة إلى الله بين اليسر والعسر
[نقد فكر منّاع قطّان أول وآخر مرشد معروف لحزب الإخوان المبتدع في السّعودية]
بسم الله الرحمن الرحيم
في لقاء صحفيٍّ [1] مع أحد مشاهير الدعاة ـ الموصوفين بالإسلاميين ـ طُلب منه بيان شروط الدعوة إلى الله التي يجب تحققها في الداعي إليه. وتأثراً بالخلق الصحفي من جانب، وبالفكر ـ الموصوف بالإسلامي ـ من جانب آخر، لجأ إلى المبالغة والتعسير والتشديد، مخالفاً شرع الله لدينه ولعباده الصالحين ـ وخيرهم الدعاة إليه على منهاج النبوة ـ قال الله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} [القمر:17] في وصف أعظم مصادر شرعه، وقال تعالى عن هديه لعباده: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} [البقرة:185]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» [متفق عليه].
ولأن الدعوة إلى الله عبادة لا يجوز الحكم فيها بغير شرع الله في كتابه وسنة رسوله وفقه الأئمة الأول؛ رأيت وجوب التنبيه على بعض أخطائه في اللغة والأحكام، والتفريق بين الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبين الفكر البشري مظنة الخطأ:
1ـ لم يوصف الداعي إلى الله في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في كلام أئمة العلم في القرون المفضلة بأنه (داعية)، وإنما انتشر هذا الوصف في الأجيال المتأخرة عندما اغتصب العلم والدعوة من لم يؤهل لأي منهما؛ قال الله تعالى في وصف أعظم الدعاة إليه: {وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً} [الأحزاب:46]، وتصحيح اللغة من واجبات المسلم إذا تعلق الأمر بشرع الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرماً [متفق عليه]، ونهى عن قول (ما شاء الله وشئت)، كما صح من رواية أبي داود، ورد على خطيب القوم قوله: «ومن يعصهما فقد غوى» [رواه مسلم]. ولو قدر العرب لغتهم حق قدرها، لعادوا بها إلى أصلها في الكتاب والسنة.
2ـ لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في كلام أهل العلم في القرون المفضلة وصف الداعي ولا الدعوة ولا العلم ولا العمل الشرعي بأنه (إسلامي) أو أنها (إسلامية) حتى جاء أهل الفكر في هذا العصر المتخلف ـ بقلة علمهم وضعف اتباعهم ـ فاخترعوا هذه الأوصاف لتستر نقصهم في العلم والعمل، بل لتتخذ وسيلة لتسويق الفكر والتجارة والتحزب ـ أي التفرق في الدين ـ باسم (الإسلام) افتراء عليه.
3ـ اشترط داعي الفكر على الداعي إلى الله (الفهم الشامل للإسلام في أصوله ومصادره ومقاصده)، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: {قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} [يوسف:108] مفسراً البصيرة ـ خلافاً لأئمة التفسير ـ بأنها (شيء فوق العلم والمعرفة)، ولو أخذ الدعاة برأيه هذا لتوقفت الدعوة إلى الأبد؛ فمن ذا الذي يحيط بالعلم والمعرفة الشرعية فضلاً عما فوق ذلك لو جاز للمسلم أن يدعيه؟ وما هو مقياس ما فوق العلم والمعرفة لو وُجد؟
4ـ أضاف شرطاً تعجيزياً آخر لا يمكن قياسه: (فهم روح الدين) ووصف الدين بـ(الروحانيات) أجنبي عن الإسلام وترجمة حرفية لوصف أعجمي لدين باطل، وتقسيم الدين إلى روح وحس أو مظهر أو مادة اختراع آخر في هذا العصر من وسوسة الشيطان للبعد عن الوحي والركون إلى الفكر مثل تقسيمه قبل هذا العصر إلى حقيقة وطريقة.
5ـ أما أئمة التفسير؛ فقد عرفوا البصيرة في الآية بأنها الحجة والعلم والبرهان واليقين، وكلها أمور يمكن قياسها ووزنها بميزان الوحي من كتاب الله وسنة رسوله وفقه أئمة الهدى في دين الله.
6ـ واشترط (المفكر) على الداعي إلى الله أن يكون (محيطاً بأحوال من يخاطبهم على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والنفسية، وما يكون لديهم من مشكلات وآلام) ولا أحسبني في حاجة إلى تأكيد استحالة تحقيق ذلك، ولو فرض أن أحد الدعاة أحاط بما يسمى علم الاجتماع وعلم النفس وبالطب على اختلاف فروعه فسينقصه علم الغيب وهو لله وحده.
7ـ واشترط المفكر على الداعي إلى الله: (أن يكون على معرفة كاملة بمتغيرات العصر، فلا يخاطب العصر الذي يعيش فيه بأحوال ومشكلات عصر سابق)، ومع استحالة القياس الثابت للمعرفة الكاملة، فإن هذا الشرط يناقض سنة الله تعالى في إرسال خير الدعاة وقدوتهم: الرسل، ويناقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة قال الله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل:36]، قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
وبين الله عز وجل في أكثر من سورة أن كل رسول قال لقومه: {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 59] بالنص أو بالمعنى، على اختلاف الزمان والمكان والحال، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته وأنهاها بأمر الله، وبعث دعاته بالتحذير من أوثان وأصنام القبور والمقبورين واتخاذها مساجد، وهي أكبر كبيرة وموبقة ومعصية يواجهها الدعاة منذ نوح عليه السلام حتى اليوم.
وثبت في صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها، قولها: (ما أخذت {ق وَالقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس)، رغم تغير الأحوال وكثرة الأحداث والطوارئ.
ومن تتبع خطب النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وخطب خلفائه وأصحابه وتابعيه وفقهاء الأمة في القرون المفضلة وجد أنها لا تعنى بالطوارئ والأحداث والتحليلات السياسية (ومتغيرات العصر)، لأن شرع الله ـ وخطبة الجمعة منه ـ لا يتغير بتغير الزمان والمكان والحال، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأهم ما يهم المسلم في أي عصر: الاستعداد للموت وما بعده، وهو مضمون سورة {ق}، وإعداد المسلم لهذا المستقبل المؤكد يكون ـ في الدعوة إلى الله على بصيرة ـ ببيان التوحيد ونقيضه الشرك، ثم ببيان أحكام الشريعة والموعظة عامة، وخطبة الجمعة عبادة توقيفية مثل كل عبادة، وهي قدوة الدعوة وأعلى درجاتها.
8ـ وفرق (المفكر) بين الخطبة والمحاضرة، وأكد العناية بالعواطف والمشاعر بكلام صادر عن الفكر لا عن الشرع، قال الله تعالى: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23]، ومن الهدى عرفنا العلم الشرعي والخطبة الشرعية وحلقة الذكر، ومن الظن والهوى جاءت المحاضرة وحديث العواطف والمشاعر ومتغيرات العصر والفتنة بالتحليلات السياسية.
هدى الله الجميع، وردهم رداً جميلاً إلى كتابه وسنة رسوله وفقه شريعته، وأعاذهم من نزعات الشيطان ونفثه.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين.
[1] في المجلة العربية مع الشيخ/ مناع قطان رحمه الله.