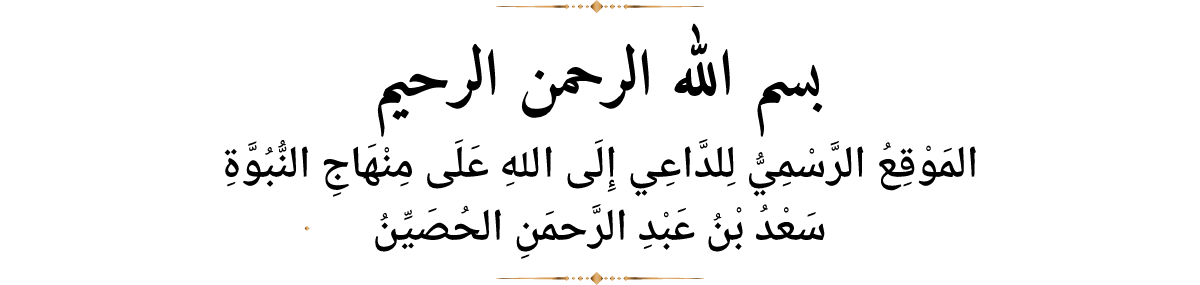العدوان بالقول على الله بغير علم
العدوان بالقول على الله بغير علم
بسم الله الرحمن الرحيم
في العدد (545) من مجلة العربي مقال بعنوان: (جدليّة الاستبداد والاستضعاف) بقلم د.يحيى الرّخاوي تأخر اطلاعي عليه لعدم المتابعة. ولم أكن لأهتم بالمقال ـ مقدماته ونتائجه ـ لأسباب منها:
1- جهلي بالطب النفسي البشري رغم دراستي الإلزامية المحدودة في ما يوصف بعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية، وخبرتي العملية في التعليم العصري والشرعي أكثر سنين حياتي.
2- عدم ثقتي بمقدمات ونتائج هذه الفنون الحديثة؛ لأنها مبنية على الظن وقد قال الله تعالى: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً} [النجم: 28].
3- ولأن الأمر ظنّي غير يقيني فلا داعي للمشاحة ولا الجدل فيه إذ هو أهون من ذلك، ولا حرج في أن يكون لكلٍ فيه رأي فإن أعلى درجة يصلها مختص أو غير مختص في هذا الشأن لا يتجاوز الفراسة الجبلية أو المكتسبة، ولا نعلم حقيقة ما في النفس والقلب وما يخفي الصدر إلا الله: {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ} [الإسراء: 25]، {أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ} [العنكبوت: 10]، «فهلا شققتَ عن قلبه»، «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن».
ولكن الكاتب هدانا الله وإياه لم يلتزم أدب البحث ولا هو التزم شرع الله بالتثبت قبل الحكم؛ بل تجاوز حدود اختصاصه النظري والعملي الظني إلى القول على الله بغير علم بتأويل ما جاء في كتاب لله من علم اليقين بما يلائم ظنّه وهواه مخالفاً تأويل الراسخين في العلم من المفسرين الأُوَل المعتد بهم وهم وحدهم من يجوز له تأويل كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وخيره بيان النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نُزِّل إليهم، وفَهْم الصحابة رضوان الله عنهم للتنزيل وأشهرهم ابن عباس وابن مسعود، وما نقله المفسرون من التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأوثقهم سعيد بن جبير، وما جمعه المفسرون بالمأثور وأكملهم ابن جرير في القرن الثالث ثم ابن كثير في القرن الثامن الهجري. أما المفسرون بالرأي وقدوتهم: عبد الجبار بن أحمد الهمداني شيخ المعتزلة في القرن الرابع، والشريف المرتضى الشيعي في القرن الرابع والخامس، والزّمخشري المعتزلي في القرن الخامس والسادس، وخلفُهم في هذا العصر: طنطاوي جوهري ومحمد متولي شعراوي وسيّد قطب تجاوز الله عنا وعنهم فلا تبرأ ذمة المسلم بتذليل الوحي اليقيني لأفهامهم الخطاءة «وكل ابن آدم خطاء»، ولا تبرأ ذمّة المسلم ببناء فهمه لشرع الله وعبادته على ظنهم وأهوائهم.
ولئلا أقع فيما وقع فيه الكاتب من القول بلا علم ـ ولو على غير الله ـ فسأضرب صفحاً عن إشارته إلى ما يسميه (مجالات ومظاهر الاستبداد من تربية الأطفال حتى ممارسات شركات الدواء) وإلى ما يصفه (بالاستبداد في الحب وفحولة الرجل وأنوثة وذكورة المرأة) وإن بدا لي ذلك مجرد لَعِبٍ بالمصطلحات لا ثقة فيه ولا فائدة منه.
ولكن لا يسعني إلا إنكار المنكر من خوضه في العلوم الشرعية على جهلٍ تامٍ بها، مثله ـ في ذلك ـ كمثل أكثر المهنيين الجاهلين بشرع الله من الكتّاب والصحفيين والأطباء والمهندسين والجيولوجيين. وليت مجلة العربي تلتزم الأمانة الفنية والخُلُقية فيما تنشر تميّزاً عن أكثر المجلات والجرايد العربية فلا تعطي القوس إلا لباريها:
أ- خالف الكاتب أئمة المفسرين بالتّفريق بين وصف الضعفاء والمستضعفين. والوصفان مترادفان لغةً واصطلاحاً، وذمُّ الله المستضعفين في الآية 97 وعذرُه المستضعفين في الآية 98 من سورة النساء لا يدل على صحّة ظنّ الكاتب بل على قلة فقهه وتدبّره؛ فإنما ذمّ الله من اعتذر كذباً بالضعف أو الاستضعاف عن الهجرة من مكة (حيث لا يتمكن من إظهار دينه) إلى المدينة (حيث يتمكن من ذلك) وقد أوجب الله عليه الهجرة قبل الفتح. وروى البخاري عن ابن عباس أن الآية 97 نزلت في أناس من المسلمين كانوا مع المشركين [يوم بدر ]يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيُرْمَى أحدهم بالسهم أو يُضْرَب عنقه فيُقْتَل؛ فأنزل الله: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء: 97]، ذكره ابن كثير وذكر مثله الطبري عن الضحاك، وليس الأمرَ كما ظن الكاتب مجرد استبداد واستضعاف.
ب- لا يظهر أن الكاتب يفرق في حكمه الفاسد بين جور الحاكم المسلم المقيم الصلاة (وكل الحكام يقيمون الصلاة بفتح المساجد وإضاءتها ومدّها بالماء، والأذان كل فرض، ونظافتها وتعيين أئمتها) وبين جور الحاكم الكافر الذي يحول بين المسلم وبين الاعتقاد الصحيح والعبادة الصحيحة (ولا وجود لهذا الحاكم اليوم على وجه الأرض بفضل الله)؛ فهو من مفهوم ظنّه يوجب على المسلم ما حرّمه الله عليه من الخروج على ما يسميه (الاستبداد والاستضعاف) وإلا كان مأواه جهنم وساءت مصيراً بحسب استدلاله بالآية 97 من سورة النساء.
وهذه مخالفات صريحة متتالية لشرع الله، ولكلام الله تعالى كما فهم السلف (وهم أهل اللغة وأهل العلم)، ولما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله له إذ كان يبايع أصحابه على ألا ينازعوا الأمر أهله، وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها» قالوا: كيف تأمر منا من أدرك ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك»، والأثرة : هي ما يعنيه الكاتب بالاستبداد والاستضعاف.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي» قال حذيفة رضي الله عنه: كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع».
واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ الأمر بالمعصية «فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، ولا ينفي ذلك تنفيذ الأمر بالمعروف ولا يجيز ذلك الخروج على ولي الأمر ولو كان ظالماً أو فاسقاً، سواء وَلِيَ الأمر بالانتخاب وغالبية الأصوات (وهو ما لم يعرف في الإسلام في القرون المفضلة ولا ما بعدها قبل القرن الأخير) أو وَلِيَ الأمر بالعهد إليه ممن قبله (كما حدث في أكثر ولايات المسلمين منذ أبي بكر رضي الله عنه) أو اغتصب السلطة فاجتمع عليه شمل البلاد وأهلها (في رأي كثير من أهل العلم وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله).
ج- وتجاوز تعدَّي الكاتب حدود تخصصه إلى إعطاء نفسه ما ليس له من الحكم بالظن على مراد الله تعالى بقوله: {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ} [القصص: 5]، وصرح بأنه إنما يظن ظناً في تأويلها بما يوافق هواه، ولا تبرأ ذمته بالتصريح باتباعه الظن، وأخطأ ولو أصاب (وهو بعيد عن الصواب في فهمه وفي قوله على الله بغير علم).
وهذه الآية محكمة يرجع في تأويلها إلى أقوال المفسرين المعتد بهم في القرون الأولى قبل ظهور الفتن والبدع والتعالم وفقد الأمانة العلمية. وما كان للكاتب وأمثاله إلا أن يطيعوا أمر الله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومتبعي سنته.
الرياض 1425هـ.