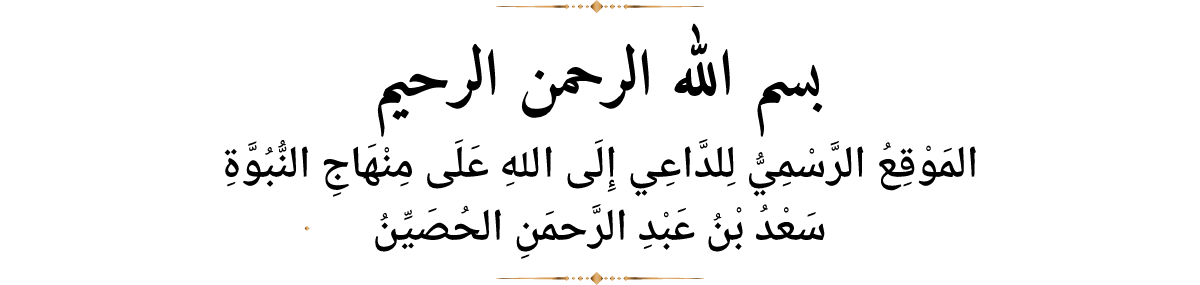التعبد بالاستحسان اختيار لغير ما قضى الله ورسوله
التعبد بالاستحسان اختيار لغير ما قضى الله ورسوله
بسم الله الرحمن الرحيم
أ) قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]؛ وجُلُّ الابتداع في الدين (الشرك فما دونه) بُنيَ على الاستحسان، قال الله تعالى عن المشركين في عبادتهم (دعائهم) الأولياء: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3] وفي الآية الأخرى: {وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ} [يونس: 18]، والاستحسان وَلَدٌ غير شرعي للعقل والعاطفة، وقد يضل العقل إذا لم يُحَدّ بوحي الله وشرعه والفقه في دينه، والعاطفة أضلّ، قال الله تعالى: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23]، وقال الله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} [الكهف:103-104]. والاستحسان (مِثْل حُسْن النية والقصد، ومثل الغيرة والحمية ولو وُصفت بأنها إسلامية) إذا لم يتقيد شيءٌ من ذلك بنصوص الوحي والفقه فيها من أهله كان ذريعةً للخروج على السنة وعلى الجماعة كما حدث لجميع الفرق التي افترقت في القرون الأولى مثل القدرية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج والمرجئة والرافضة، وكل من انخزل بعدهم عن السنة والجماعة كالمتصوفة وبقية الأحزاب والجماعات المحْدَثة التي فرّق بها الشيطان المسلمين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «… وستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي».
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم).
وقال الإمام مالك رحمه الله: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها).
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: (من استحسن فقد شرّع)، ولـه رسالة طُبعت على هامش (الأم) بعنوان (إبطال الاستحسان).
وقال ابن تيمية رحمه الله: (والقول بالمصالح المرسلة [قد] يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، وهي تُشبه من وجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي.. لكن ما اعتقده العقلُ مصلحةً وإن كان الشرع لم يَرِدْ به فأحد الأمرين لازم له؛ إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين أو الدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة..
والقول الجامع: أن الشريعة لا تُهمِل مصلحة قط، بل الله قد أكمل لنا الدين وأتم [علينا] النعمة.. وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام والتصوف حسبوه نافعاً وحقاً صواباً ولم يكن كذلك). مجموع الفتاوى (11/344 – 345).
وقد سول الشيطان والنفس الأمارة بالسوء للمبتدعة تسويغ ضلالهم بدعوى البدعة الحسنة، ولا يكون في الدين بدعة حسنة.
وقد قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» [رواه مسلم]، واستدلالهم بحديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها…» على جواز الابتداع في الدين باطل ظاهر لم يقل به عالم بشرع الله؛ فالسنة مخالفة ومناقضة ومحاربة للبدعة، ويستحيل شرعاً وعقلاً أن تُسَنّ السنة الحسنة بالابتداع في الدين، وإنما تُسَنّ السنة الحسنة بالتذكير بها إذا نُسيت، وتجديدها إذا اندثرت كما ورد في حديث «تجديد الدين على رأس كل قرن» أي: بالعودة به إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكما ورد في حديث الصدقة.
ب) ومن أكبر الكبائر والموبقات التي جرّها الاستحسان على الإسلام والمسلمين بعد القرون المفضلة: بناء المساجد على القبور اتباعاً لليهود والنصارى والوثنيين، وكان آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأهمها التحذير من ذلك وأهمها: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة رضي الله عنها: (يحذِّر ما صنعوا) [متفق عليه].
ثم صار أكثر المسلمين يَدْعون من سُمِّيَتْ باسمه ويذبحون وينذرون له ويستغيثون به ويطلبون منه المَدَد ويشركونه مع الله في ألوهيته وربوبيته كما يُفعل بالحسين في العراق وسوريا ومصر، وبالخضر في بلاد كثيرة، وبزينب في دمشق والقاهرة، وبعلي وابن عربي والبدوي وشعيب، وفي المسجد الإبراهيمي في الخليل أربعة أوثان لليهود خافية، وسبعة أوثان للمسلمين ظاهرة.
وفي بلاد العرب والعجم آلاف الأوثان للمنتمين للإسلام لا تختلف عن الأوثان منذ قوم نوح إلا بتسميتها (مقامات ومشاهد ومزارات وأضرحة) وفي صحيح البخاري وتفسير ابن جرير رحمهما الله أن (وَدّاً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً – آلهة قوم نوح – كانت أسماءً لرجال صالحين فلما ماتوا استحسن مَن بعدهم – بوحي من الشيطان – بناء أنصاب في مجالسهم تذكرهم بأعمالهم الصالحة ليقتدوا بهم، وانتهى الأمر بعبادتهم).
ج) ومن أسوأ نتائج الاستحسان أثرا ًعلى الإسلام والمسلمين: نَبْذُ أكثر المسلمين منهاج النّبوّة (الذي اختاره الله لهم ووحَّدهم عليه رغم اختلاف الزمان والمكان والحال) في الدعوة إلى سبيل الله وصراطه المستقيم، واتباع المناهج المحدثة والسبل المبتدعة التي استحسنها الخارجون عن السنة والجماعة لغرضٍ سياسي (كالخوارج سابقاً والإخوان المسلمين والتحرير والجهاد لاحقاً) أو لِهوىً سلوكي (كالصوفية والتبليغ)، مخالفين قول الله في محكم كتابه المبين: {قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108]، وقولـه تعالى: {وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153]، وقولـه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء} [الأنعام: 159] ومُستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ فتخلت الدعوة المُحْدَثة عن العلم والعلماء بشرع الله واحتضنت الفكر والمفكرين، وأُقْصِيَ عن الصدارة الوحي من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ليحتل مكانه الشعر والفكاهة والقصة والإشاعة وخبر الجريدة والإذاعة.
وأُقصي عن الصدارة الفقه في الدين ليحتل مكانه فقه الواقع والحركة والموقف والمرحلة.
وأشنع ما يكون استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ حين يُقصي الدعاة يقين الوحي والفقه فيه (من أهله) ويدنون ظن الفكر في فريضة من فرائض الله فيحولون خطبة الجمعة عما قضى الله وسن رسوله من تعليم المسلمين أمر دينهم إلى ما اختارته النفس والهوى والشيطان من التحليل السياسي، والتهيج، أو التفيهق اللغوي، أو التذكير بروايات ووسائل الإعلام، وسوغ ذلك أحد أشهر الخطباء في أعظم المساجد بتغير الأحوال، وكأن شرع الله غير صالح لكل حال، تجاوز الله عنه وعذره بجهله الذي لم يخرجه منه لقب الدكتوراه في بعض العلوم الشرعية.
د) ومن سيئ نتائج الاستحسان تقديم الرأي المذهبي على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة بحجة أن من نُسب إليه المذهب الموروث أولى بمعرفة الحق ودليله من المتأخرين، وأن المتأخر بين أمرين: إما التقليد أو الاجتهاد، وهو غير أهل للاجتهاد فلم يبقَ له إلا التقليد.
وكلا المقدمة والنتيجة باطل، وإليك البيان:
1 – من نُسب إليه المذهب من الأئمة المعتد بهم (مع الاعتراف بفضل الله عليه وفضله به، وتميُّزه بالعلم والعمل، وقُربه من عصر النبوة والخلافة والصحبة والاتّباع، وحياته وموته في القرون المفضلة)؛ فهو من ولد آدم «وكل ابن آدم خطّاء»، وقد يفوته العلم بالدليل في حكم شرعي أو يفوته استحضاره.
2 – ومع أن الدراسة العصرية في أعلى درجاتها لا تبلغ بطالب العلم درجة المجتهدين الأوائل؛ لضعف المدارك والمناهج الدراسية المجزأة، وكثرة الملهيات والصوارف عن الشمول الذي تميز به فيما مضى طلب العلم الشرعي ومنه آلة الوصول إليه؛ فلا يزال عدد قليل من طلاب العلم يتجاوز حدود التنظيم العصري للتعليم بالمثابرة والطموح إلى أُفق العلم الشامل كأبي زيد رحمه الله والمدخلي والفوزان والحلبي والهلالي ومشهور نصر الله بهم دينه.
3 – وليس المسلم محصوراً بين التقليد والاجتهاد؛ فقد شرع الله للمسلم أمراً ثالثاً وسطاً بينهما وفرضه على جميع عباده لا يحُدُّه إلا حد الاستطاعة؛ وهو الاتّباع قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} [الأحزاب: 21]، وقال تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، وقال الله تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم} [الزمر: 55].
4 – وشرع الله للأمّيّ ولمن يشق عليه معرفة الحكم الشرعي بدليله أن يسأل أهل الذكر (وهم العلماء بشرع الله)؛ وقال الله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 43 ]؛ فليس الخطأ في التقليد مطلقاً، وإنما الخطأ والمعصية الكبرى في التعصب للمقلَّد بعد أن تبيَّن مخالفة رأيه الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
هـ) ومن سيئ نتائج الاستحسان اختيار الأدنى على الأَوْلى والمهم على الأهم في أمور كثيرة من أمور الدين يصعب حصرها، ومن ذلك:
1 – تقديم حفظ القرآن على تدبره تأسِّياً بالأعاجم؛ تجتمع على ذلك كل فرق المسلمين وطوائفهم وأحزابهم؛ فيقدِّمون النافلة على الفريضة ويكتفون بالأدنى عن الذي هو خير، وكان الصحابة وتابعوهم رضي الله عنهم (لا يتجاوزن عشر آيات حتى يعلموا معانيهن والعمل بهن) استجابة لأمر الله تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} [ص: 29]، {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ} [البقرة: 121] أي: (يتبعونه ويعملون به) بعد معرفة أوامره ونواهيه وحلاله وحرامه، أما مخالفوهم من الخوارج في الماضي والحاضر فإنهم «قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» [متفق عليه].
2 – اختيار التفسير الخَلَفي للقرآن ـ عند الالتفات للتفسير ـ (وفيه القول على الله بغير علم) على التفسير المأثور عن أئمة الدين في القرون المفضلة الثابِتِيْن على منهاج النبوة؛ وبعد أن كان التفسير مبنياً على يقين الوحي والفقه في الدين موحَّداً على ميزان الحق والعدل فرَّقته شطحات المتصوفة والباطنية وأوهام المتفلسفة وآراء المتكلمين من قَبْلُ بدعوى الإلهام، وظاهر القرآن وباطنه، وأسراره، ومن بَعْدُ بدعوى الإعجاز العلمي والتصوير الفني في القرآن، وأوهام الفكر الموصوف بالإسلامي.
3 – اختيار الفكر على العلم، والمفكر على العالم، والقاصّ على الداعي إلى الله على بصيرة، والموعظة بزخرف القول على الموعظة بالقرآن والسنة، واسم ورسم (المحاضرة والندوة) الفكري على اسم ورسم (حلقة الذِّكْر والدرس) الشرعي.
4 – تزويق وتحلية ونقش المصاحف وتجزيء وتخريب القرآن والاهتمام بالشكل وعدد الحروف والكلمات على نحوٍ لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه وأصحابه ومتبعي سنته في القرون المفضلة بل اتّباعاً للاستحسان وما تهوى الأنفس.
5 – زخرفة المساجد بالنقوش وكتابة أسماء الله وأسماء بعض عباده وآيات من كتابه (كأنما أنزله الله لِتُزَيّن به الجدران والسقوف أكثر من تدبره والعمل به وتبليغه)، بل المبالغة والإسراف في زخرفة وتزيين المساجد برموز العمارة الكنيسية النصرانية (القبب والأقواس والتيجان والمحاريب والثريات الفارهة والمآذن المزدوجة على واجهة المسجد تصديقاً لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)، ومخالفة لقول عمر رضي الله عنه لمن ولاه توسعة المسجد النبوي: (أكنّ الناس من المطر وإياك أن تحمّر أو تصفّر فتفتن الناس) وكلا الأثرين في صحيح البخاري، بل تحقيقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» [متفق عليه].
6 – الاهتمام بصلاة التراويح (النافلة) في المسجد مع الجماعة أكثر من صلاة الفريضة؛ مخالفةً لشرع الله، وزيادة عدد ركعاته ونقص الركوع والسجود والتشهد؛ مخالفة للسنة، وتكثير الدعاء في القنوت وختم القرآن وتقليله في السجود والتشهد؛ خلافاً لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم.
و) ومن سيئ نتائج الاستحسان الالتزام بما لا يلزم تقرُّباً بما ليس بقُرْبة ومنه:
1 – الاحتفال بذكرى الهجرة والإسراء والمعراج والمولد ونحوه مما لم يعرفْه ولم يأمر به ولم يعمل به السابقون المقربون: الرسول والخلفاء والصحابة ومن تبعهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [متفق عليه].
2 – خلع النعال للصلاة ولدخول المسجد (ولو لم يُفرش)، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال مخالفة لليهود.
3 – لبس المرأة البياض للصلاة والإحرام بالحج والعمرة ظناً بأنه مما شرع الله وخصّ به عبادة المرأة، وهو أقرب إلى التشبه بالرجال.
4 – ترتيل جملة (صدق الله العظيم) بعد تلاوة الآية أو الآيات من كتاب الله في غير الصلاة، وقد يقع في ذلك بعض علماء العصر اقتداءً بالعوام، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه.
5 – التزام وصف مكة بالمكرمة والمدينة بالمنورة خلافاً للوحي والفقه فيه.
6 – تعسير القرآن (وقد يسَّره الله للذكر) بإيجاب الأخذ بما سُمِّي (أحكام التجويد) بلا دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله، بل بقول الناظم: (والأخذ بالتجويد حتمٌ لازم)، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه بتاريخ 1415/11/13هـ: (لا أعلم دليلاً شرعياً على وجوب الالتزام بأحكام التجويد)، وقال مثل ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في كتاب العلم (ص:171)؛ فإنه لا يرى المسلم مُلزَماً إلا بالإعراب؛ لأن القرآن أُنزل بلغة العرب، ولضرورة الإعراب الصحيح للتدبر.
أما من ظن الأخذ بقواعد التجويد واجباً شرعياً (أو سُنَّة) فربما أُتي من جهة الخلط بين التجويد المحْدَث والترتيل في قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً} [المزمل: 4].
والترتيل في الآية معناه التمهل والترسل في التلاوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومنه قول الله تعالى: {وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً} [الفرقان: 32]، {ونزلناه تنْزِيلاً} [الإسراء: 106] مفرقاً ومبيناً.
ويُغْرِق بعض المتعصبين لإرثهم من القول على شرع الله بغير علم فيدّعي التواتر في نقل قواعد التجويد، وليس لأكثر قواعد التجويد سند صحيح ولا حسن ولا ضعيف فضلاً عن التواتر، وبعضها يخالف شرع الله، ويلي بعض الأمثلة:
7 – الالتزام والإلزام بعدم الوقوف على نهاية بعض الآيات بحجة بيان المعنى مخالفة لقضاء الله وسنة رسوله، واتهاماً لهما بعدم البيان، دون قصد لذلك، فيما نظنّ بمقترفه.
8 – تكلف نطق بعض كلمات الله بغير اللغة العربية المعروفة للناس مثل {مجِريْها} بالإمالة و{تأمَنّا} بالإشمام، وقد أُنزل القرآن على سبعة أحرف ليقرأه كلّ مسلم بالحرف الذي قُدِّر له.
9 – تكلف السكتة [غير] اللطيفة في مثل {بل ران} [المطففين: 14] و{من راق} [القيامة: 27]، مخالفة لما يعرفه الناس من لغتهم وما يسر الله لهم من نطق وفهم.
10 – تكلف القلقلة لإظهار حروف القلقلة الساكنة، إلى درجة تغيير السكون على الباء في {إبراهيم} و{أبواب} مثلاً إلى الكسرة عند بعض كبار الأئمة فضلاً عن صغارهم؛ فيقعون في اللحن الجلي.
11 – تكلف ترتيل الاستعاذة (وليست من القرآن) والبسملة (وهي كذلك غالباً)، وربطهما بالآية الأولى من السورة (اختياراً) والسنة تفريقهما.
12 – تكلف إعادة جزء من الآية عند الوقوف قبل نهايتها بحجة تبيين المعنى ولم أر في السنة ولا القدوة الصالحة ما يؤيد هذا التكلف، بل تدل نهاية كثير من الآيات (رغم ارتباط معناها بالآية بعدها) على عدم مشروعية الإعادة؛ في مثل الآيات أول سورة الروم فضلاً عن مثل آية: {فويل للمصلين} [الماعون: 4]، وآية: {ألا إنهم من إفكهم ليقولون} [الصافات: 151] توقيفاً من الله في كتابه وسنة رسوله.
13 – تكلف الإدغام في مثل: {بل رفعه الله إليه} [النساء: 158] مقارناً بتكلف القلقلة، وكره أحمد حذف حرف أنزله الله تعالى.
ولأئمة السنة (ابن الجوزي، وابن تيميه، وابن القيم خاصة) رحمهم الله جميعاً تحذير من هذا الابتداع والتكلف والتعسير، وفق الله الجميع لأقرب من هذا رشداً.
(1429هـ).