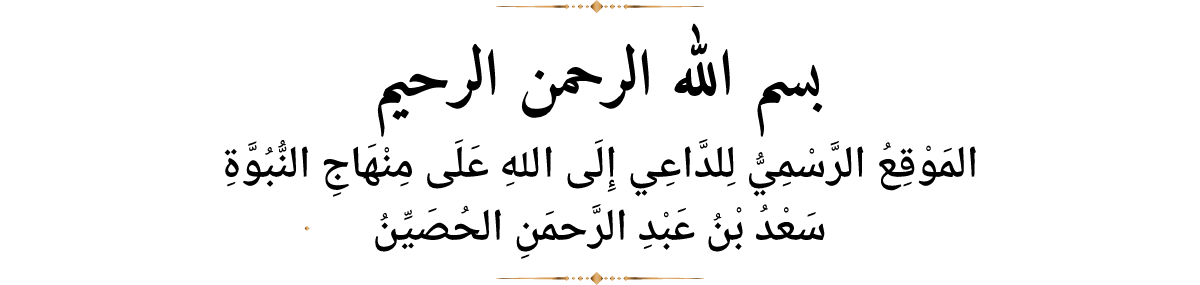الرأي والفكر لا يكون شرعا لله ولو راعى المصلحة والعدل
الرأي والفكر لا يكون شرعا لله ولو راعى المصلحة والعدل
بسم الله الرحمن الرحيم
عنونت إحدى مقالاتي (المجموع الأول 1424 ص103) بعنوان: (المشاحة في الاصطلاح) مثالاً على المصطلحات المبتدعة التي استعاض بها ضلال الأمة عن الدليل مكان كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعن فقه الأئمة الأول في نصوصهما. وحاولت أن أبين أن هذا مجرد قول لا يعرف لقائله اسم ولا رسم، ولو عرف لما جاز الأخذ به (على الإطلاق) كائناً من كان، إذ لا بديل للدليل الشرعي (من الوحي والفقه فيه من أهله الأول) منذ القرون المفضلة حتى قيام الساعة، ولو جازت المشاحة في شيء لكان أولى بها الأمر بالمعروف، بل والنهي عن المنكر وفق شرع الله.
وقبل سنوات عديدة لا قبل لي باحصائها سمعت من خير معلمي وأقربهم وأحبهم إليّ مصطلحاً آخر عزاه إلى أحد أكبر فقهاء القرن الثامن الهجري: (حيث توجد المصلحة فثم شرع الله) وبدا لي أخطر من: (لا مشاحة في الاصطلاح) ولكني لم أر الإلحاح في إنكاره لأن الذي عزاه خير مني في العلم الشرعي الذي أحبه وأقصر عنه، وفي الفكر الإسلامي (زعموا) الذي أتهمه وأحْذَر وأحَذِّر منه، ولأن من عزى إليه علم في العلم والحكمة والدعوة إلى الله على بصيرة، فسوفت النظر في الأمر حتى يأذن الله.
وبعد عشرات السنين تردد مصطلح المصلحة والشرع على ألسنة بعض الكتاب تأييداً لتوسعة المسعى الثانية، وبعد البحث تبين لي أنه محرف من قول ابن القيم رحمه الله في أكثر من كتاب: (فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثَمَّ شرع الله ودينه) ويعين على فهم مقصوده ما قاله قبله في (أعلام الموقعين ج4 ص373)، عن (اختلاف العلماء في العمل بالسياسة) أيْ: [بغير النصوص التي نزل بها الوحي وفقهها السلف]: فقال بعضهم: (العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلو منه إمام وإن لم ينطق بذلك الشرع، مثل تحريق الصحابة المصاحف وتحريقهم الزنادقة ونفيهم من خشي منه أو عليه فتنة النساء)، قال ابن القيم: (هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، في معترك صعب، فرَّط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرؤوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة، لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة يعرف بها المحق من المبطل، ظنًّا منهم منافاتها لقواعد الشرع، فلما رأى ولاة الأمر أن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة؛ أحدثوا لهم قوانين سياسية، ينتظم بها مصالح العالم، فتولَّد من تقصير أولئك في الشريعة، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم: شرٌّ طويل، وفساد عريض.
وأفرطت طائفة أخرى فسوغت ما يناقض حكم الله ورسوله.
وكلا الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله).
ولم أر في قول ابن القيم رحمه الله إلا التوسعة في الاجتهاد ممن أهلهم الله له (في: الطرق، والوسائل والأدوات، بخاصة) لتنفيذ حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لا لإحداث شرع لم يأذن به الله (كما قد يفهم الكتاب والصحفيون من الاصطلاح المبتدع)، في أمر من أمور الاعتقاد أو العبادة أو المعاملة، بل يرد ابن القيم رحمه الله وينكر بدعتين: العدول عن الاستنباط من وحي الله بفقه الخلفاء والمعتد بهم بعدهم في القرون المفضلة، ويكثر ذلك في المقلدين في عصره، والإحداث زيادة على الشرع المنزل بالحق من رب العالمين، ويكثر في كل عصر بعد القرون الخيرة.
ولا يليق بهذا العلم من أعلام الفقه في الدين أن يظن به ترك تقدير المصلحة والعدل لكل من هب ودب ثم نسبة ذلك إلى (شرع الله ودينه)، وما أكثر الهابِّين والدابِّين في هذا العصر من الصحفيين والمفكرين وحملة الألقاب الدراسية الأعجمية تقف بهم عن مراقي العلم العليا التي تسنَّمها مثل ابن القيم فمن فوقه من الفقهاء في الدين بلا لقب أعجمي ولا قلم رصاص ولا مصباح كهربائي ولا مكتبة مطبوعة ولا آلية. وخير من قول ابن القيم قول شيخه ابن تيمية (رحمهما الله) الذي أنقذه الله به من درك الانحراف العقدي الأشعري والسلوك الصوفي. قال رحمه الله (في مجموع الفتاوى ج11 ص343): (والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبًا. وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك … والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم [علينا] النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان (11/344) الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة، وإن اعتقده مصلحة … وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعًا وحقًّا وصوابًا ولم يكن كذلك، بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} … وهذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا. فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه، والكفار فيهم هذا وفيهم هذا، وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين القسمان. فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث (11/345) يخطؤون تارة ويتعمدون الكذب أخرى، فكذلك هم في أحوال الديانات، وكذلك في الأفعال قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم وهو ظلم، فإن الإنسان كما قال الله تعالى: {وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} فتارة يجهل وتارة يظلم؛ ذلك في قوة علمه وهذا في قوة عمله).
ويقول ابن تيمية رحمه الله (في منهاج السنة النبوية ج5 ص129): (فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى).
وهل تسوغ المصلحة أو العدل – إذا تحقق أي منهما – في النظم والقوانين الأوربية والأمريكية – مثلاً – نسبة شيء منها لدين الله وشرعه؟ كثير من المسلمين يلجأ إلى أي منهما لعلمهم أن القوانين تفرض عليهم قبول اللاجئين من أي مكان بسبب الفتن والحروب فتوفر لهم السكن والمال والوظائف. وفي ذكرى مرور (200) سنة على إقرار الدستور الأمريكي 1987 حاولت مجلة التايم العالمية الأمريكية المقارنة بين النصوص وبين واقع التنفيذ، وكان من بين أمثلة التوافق قضية متسول استرالي منعته شرطة المواصلات تحت الأرض في نيويورك من التسول بآلته الموسيقية، فقاضاها وكسب القضية واستأنف التسول كالعادة إلا أن أفراد الشرطة صاروا يحيونه بعد ما كانوا يمنعونه، فتحققت المصلحة والعدل في نظر المتسول والمحامي والقاضي؛ أما شرع الله ودينه فمنزه عن الجميع.
(1429/9/11هـ).