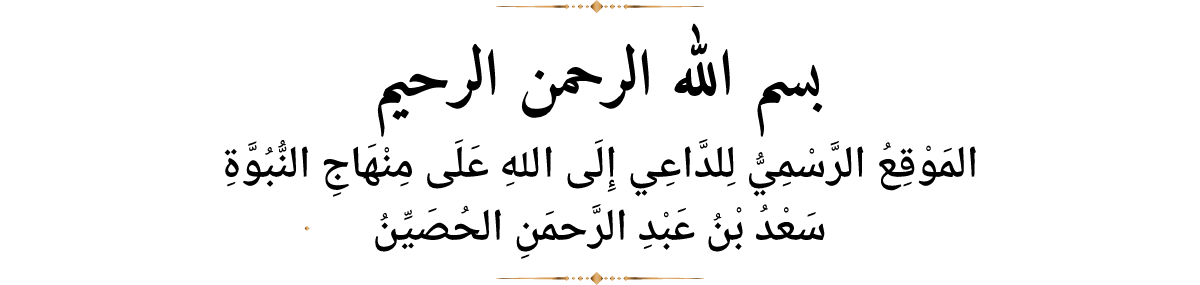لعلّ إظهار أكثر التّطوّع بالعمل الصّالح خير من إخفائه
لعلّ إظهار أكثر التّطوّع بالعمل الصّالح خير من إخفائه
بسم الله الرحمن الرحيم
يظنّ أكثر النّاس وجوب إخفاء التّطوّع بالعمل المشروع خشية الرياء، ولم أجد لذلك سندا من الكتاب والسّنّة بفهم الصّحابة رغم استعانتي بالله ثمّ ببعض من يظنّون هذا الظّنّ، فلم يبق إلاّ الاستحسان بلا دليل، وهو بريد الابتداع.
أمر واحد – فيما أعلم – ندب الله ورسوله إليه وهو إخفاء الصّدقة على فرد أو أفراد معيّنين حتى لا تنكسر قلوبهم – فيما يظهر لي – ومع ذلك قال الله تعالى: {إن تبدوا الصّدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}، وقال الله تعالى: {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنّهار سرّاً وعلانية فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون}.
ومَدَح النّبيّ صلى الله عليه وسلّم رجلاً تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ومَدَحَ صاحب الصّدقة المعلنة في قوله: ” من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة“، ومَدَح عُثْمَان رضي الله عنه لتجهيزه علناً جيش العُسْرة، وكان يسأل المتصدّقين من أصحابه عمّا أبقوا لأهلهم فربّما كان الجواب: النّصف أو الثّلث أو: أَبْقَيْتُ لهم الله ورسوله.
وإذا لم يوجد دليل من الوحي على وجوب إخفاء التّطوّع فلعلّ إظهاره اليوم أولى (بعد العمل بخاصّة، وللنّفقة على غير معين) بعد أن غلب علينا الشّحّ والغفلة نستغفر الله ونسأله الهداية.
وأكثر ما يرى النّاس إخفاءه بعد النّفقة: التّطوّع بصلاة النّافلة، وقد يستدلّون بما ورد عن النّبي صلى الله عليه وسلم: أنّ خير صلاة الرّجل النافلة في بيته، ولكنّه بيّن السّبب: لا تجعلوا بيوتكم قبورا.
وعلى أيّ حال، فهم يقترفون معصية أشنع؛ وأكثرهم يخالفون منطوق الحديث ومفهومه فيما هو أعظم، فأكثرهم يتّخذون القبور مساجد، ويتسابق علماؤهم على التّبرك بكناسة القبر (كما يقول المنفلوطي رحمه الله) ورأيت عمائمهم تطوف على القبر في كلّ مرّة دخلتُ مسجد الحسين أو الشّافعي في مصر، وما هو أسوأ في دول المنتمين للإسلام عدا السّعوديّة.
ومن لا يدعوا صاحب قبر ولا ينذر له ولا يطوف بالقبر فهو لا ينهى عن الصّلاة في المسجد المبنيّ على قبر ولا يمتنع منها.
وأمر قد يتّفق عليه الجميع: إخفاء الوتر، وإذا لم يظهر دليل من الوحي فلعل هذا مما يسمّيه بعض الفقهاء: النّسك الأعجمي، فإنّ الأعاجم – مثل الأعراب – أجدر ألاّ يعلموا حدود ما أنزل الله لعُجْمَتِهِم وعاطفتهم الدّينيّة الجيّاشة، فيتّبعوا الهوى والظّنّ والعاطفة.
ومنذ فُتِح باب الاستقدام من بلاد المسلمين – وكلّها فُتِن منذ قرون عديدة بوثنيّة المقامات والمزارات والمشاهد، وما دون ذلك من الابتداع في الدّين – تسلّلت إلينا – مع الفِرَق والأحزاب الموصوفة – خطأ – بالإسلاميّة، وقبلها وبعدها – بدعة إخفاء الذّكر ومعها حديث لا يصحّ: خير الذّكر الخفيّ.
وكان علماؤنا وعوامّنا يجهرون بالتّهليل بعد الصّلاة المفروضة، وانفرد – فيما أعلم – ابن عثيمين رحمه الله برفع صوته بالتّهليل والتّسبيح والتّحميد والتّكبير كله بعد صلاة الفريضة مستدلاّ بحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما في الصّحيحين: كُنَّا نعرف انتهاء الصّلاة برفع أصواتهم بالتّكبير، ولولا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بعد الصّلاة لما نُقِل إلينا ما كان يقول.
وورد في صلاة التّطوّع بالليل أنّ أبا بكر رضي الله عنه كان يخفض صوته بالقراءة في صلاة الليل فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يرفعه قليلاً، وأنّ عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته بالقراءة فأمره أن يخفض صوته قليلاً.
وهذا بيان قول الله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}، ومثله قول الله تعالى: {واذكر ربّك في نفسك تضرّعا وخيفة ودون الجهر من القول}؛ فخيْر الذّكر ما يكون دون الجهر وفوق الإخفات، وفهمت من الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة أنّ أبا حنيفة والشافعي وأحمد رأوا أنّه لا تجزئ قراءة المصلّي ما لم يُسْمِع نَفْسَه، ورأى مالك أنّها تجزئ بتحريك الشّفتين، قلت: وإذا فُسِّر (الذِّكر في النّفس) كما ورد في الآية والحديث بأنّه ذِكْر القلب دون اللّسان والشّفتين (كما فُهِم من بعض العلماء) فكيف يكون القول (التّلاوة والتّسبيح والدّعاء) وهو لم يُتَلَفَّظ به؟ وكيف يُرَتَّل القرآن ويُتَغَنَّى به ويُخْرَج اللَّفظ من مَخْرجه؟ وكيف يُفَرَّق بين السّين والصّاد، وبين الظّاء والضّاد؟ وهلمّ جرّا.
وكان القريب من مقام النّبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يَسْمع قراءته وغيرها من الذِّكر في صلواته كلّها؛ فنقلها الصّحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلينا.
ولعلّ من يعلم أكثر من هذا يدلني عليه بدليله وفقهه، وله الأجر.
كتبه/ سعد بن عبد الرحمن الحصيّن في 1434/12/8هـ بمكة المباركة